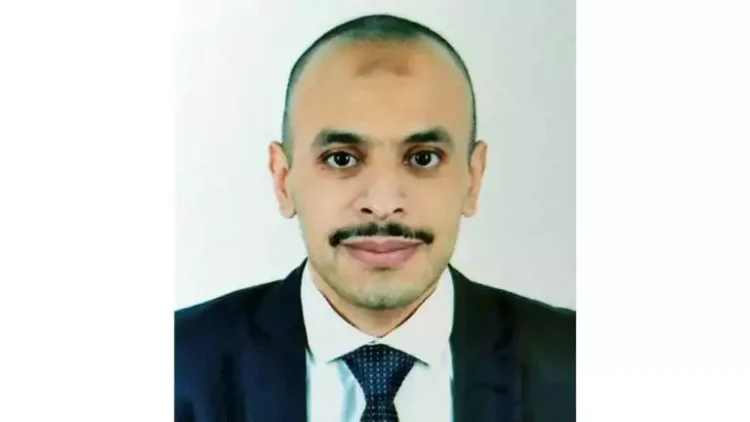جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
يحل علينا السابع والعشرون من شهر ديسمبر بذكرى ميلاد الدكتور «مصطفى محمود» لسنة 1921م، والذي توفي في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لسنة 2009م، حيث يُعد من ألمع كتّاب القرن الحادي والعشرون، ويرجع السبب في ذلك لِمَا تركه من مؤلفات كادت أن تتخطى التسعون كتابًا. وعلى الرغم من دراسته للطب، حتى أصبح طبيبًا، إلا أن عمله لم يشغله عن التأمل والتدبر بمجريات الكون، والعالم من حوله.
عاش «مصطفى محمود» حياة الطبيب الثائر على الثوابت، المُحب للمعرفة، المُخلص للحقيقة، لذلك جاءت صرخاته مدوية في شتى المجالات، محملة برؤى، ويقين لم يسبقه أحد من قبل، ولعل ذلك يرجع إلى مدى الثقافة التي نبت عليها، خاصة مع فترة مرضه التي جعلته طريح الفراش أكثر من ثلاثة أعوام، إلا أن المحنة كانت منحة له، وصنعت منه الطبيب الفيلسوف صاحب المبادئ والقيم الرشيدة.
ومصداقًا للقول “لا يموت الكاتب بمؤلفاته”، قدم لنا «مصطفى محمود» في العدد الأول من مجلة الهلال لسنة 1978م، مقالًا تحت عنوان «اللذة في الحب.. هل هي العذاب والألم؟» فجاء هذا المقال بمثابة روشتة رصد به أهم الظواهر والاحساسات الإنسانية، كاللذة والحب والرحمة، فهي الحبال الواصلة والرابطة الأساسية بين الناس جميعًا، فبدونها لن تستقيم الحياة كما ينبغي، وإلى نص المقال:
المرة الوحيدة التي جاء فيها ذكر الحب في القرآن هي قصة امرأة العزيز التي شغفها فتاها «يوسف» حبًا فماذا فعلت امرأة العزيز حينما تعفف يوسف الصديق.. وماذا فعلت حينما دخل عليهما الزوج.. لقد طالبت بإيداع يوسف السجن وتعذيبه «قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب اليم».
وماذا قالت لصاحباتها وهي تروي قصة حبها «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين». إن عنف حبها اقترن عندها بالقسوة والسجن والتعذيب، ولان قصة الحب إذا خالطتها الشهوة لم تلبث أن تنتهي الى الإشباع في دقائق ثم بعد ذلك يأتي التعب والملل والرغبة عند الاثنين في تغيير الطبق وتجديد الصنف لإشعال الشهوة والفضول من جديد.. لهذا ما يلبث الحب أن يتداعى ويتحول إلى شك في كل طرف من غدر الطرف الآخر.
وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الارتياب والتربص والقسوة والغيرة والشك، ويتحول الحب إلى تماسه، وآلام، ودموع، وتجريح. والحب لا يكاد ينفك ابدًا عن هذا الثالوث (الحب والجنس والقسوة).. وهو لهذا مقضى عليه بالإحباط وخيبة الأمل ومحكوم عليه بالتقلب من الضد الى الضد ومن النقيض الى النقيض. فيرتد الحب عداوة وينقلب كراهية وتنتحر العواطف.. وذلك هو عين العذاب.
ولهذا لا يصلح هذا الثالوث أن يكون أساسًا لزواج، ولا يصلح لبناء البيوت ولا يصلح لإقامة الوشائج الثابتة بين الجنسين. ومن دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينما ذكر الزواج لم يذكر الحب، وانما ذكر المودة والرحمة والسكن، سكن النفوس بعضها إلى بعض، وراحة النفوس بعضها إلى بعض.
وقيام الرحمة لا الحب.. والمودة لا الشهوة «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة». إنها المودة والرحمة، مفتاح البيوت والرحمة تحتوي على الحب بالضرورة… بينما الحب لا يشتمل إلى الرحمة، والرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر.
والرحمة عاطفة انسانية راقية مركبة، ففيها الحب وفيها الاخوة وفيها الصداقة، وفيها الحنان، وفيها التضحية، وفيها انكار الذات، وفيها التسامح، وفيها العطف، وفيها الكرم. كلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية.. وقليل منا هم القادرون على الرحمة.
أخذنا مقال الدكتور «مصطفى محمود» إلى رحلة في أعماق أعظم وأرقى الصفات الإنسانية، فجاءت فكرته تنبض بتحليل واضح وصريح، فند به المعاني التي اختلطت على الكثير من الكّتاب والمفكرين. ولتضح أمام أعيننا تلك الإحساسات التي تتبع اللذة، ليضع بين أيدينا الدواء الشافي ليمنع تخبطنا يومًا ما، وكيف لنا أن نُرشد استخدمنا لهذه الإحساسات، فتأتي هذه المقالة، بمثابة روشتة كتبها طبيب بقلم فيلسوف.